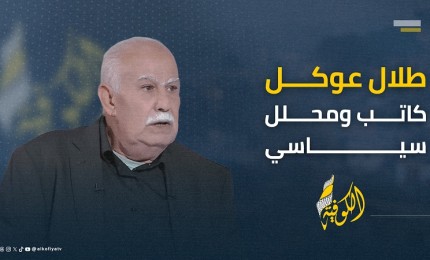نتنياهو يرشّح ترامب للسلام… بينما يغرق غزة في الإبادة

مصطفى إبراهيم
نتنياهو يرشّح ترامب للسلام… بينما يغرق غزة في الإبادة
الكوفية نحن أمام مشهد سياسي سريالي، مجرم حرب يرشّح مجرمًا آخر للسلام، مشهد يتحدى المنطق والأخلاق، يقدّم بنيامين نتنياهو توصية لترشيح دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام، بينما تُرتكب في غزة واحدة من أبشع الجرائم في التاريخ الحديث: إبادة جماعية موثقة بالصوت والصورة، وبصمت دولي مخزٍ.
تحت قصف لا يتوقف، وتجويع ممنهج، واستهداف مباشر للمدنيين، يحاول قادة الاحتلال التلاعب بالسردية العالمية، وتقديم أنفسهم كصناع سلام، فيما الدم الفلسطيني لم يجف بعد.
أيام الإبادة الجماعية ليست مجرد لحظات رعب دامية، بل لحظات انكشاف عميق. ما يجري في غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 ليس فقط قتلًا جماعيًا ممنهجًا، بل إعلانٌ صارخ عن انفصال دولة الاحتلال عن القيم الإنسانية. لقد تحوّلت الحرب إلى مسرح يومي للفجور الأخلاقي.
مع كل ارتفاع في عدد الضحايا، وكل حي يُسوّى بالأرض، يخرج مسؤولون إسرائيليون ليحتفلوا بـ”إنجازات” الحرب. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه صرّح أن الحرب “أعادت تشكيل المنطقة”.
لكن عن أي تغيير نتحدث؟ هل يُقاس التغيير بعدد الشهداء، الأطفال، والبيوت المدمّرة؟
في واحدة من أكثر اللحظات فظاعة، يقدم نتنياهو ترشيح ترامب المتهم بدوره بتغذية خطاب الكراهية لنيل جائزة نوبل للسلام، في وقت تُرتكب فيه إبادة جماعية في غزة. المفارقة أن ترامب ذاته دعم علنًا سياسات الحصار، وبارك العمليات العسكرية على غزة.
تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية، توثّق استخدام إسرائيل للقصف العشوائي والحصار الخانق في ظروف ترقى إلى “عقاب جماعي” وجريمة حرب وفقًا لاتفاقيات جنيف. أكثر من 55,000 شهيد، ونحو 200,000 مصاب، معظمهم من النساء والأطفال، في واحدة من أكثر العمليات العسكرية دموية منذ الحرب العالمية الثانية.
قُصفت المستشفيات، جُففت مصادر المياه، ومُنعت المساعدات، فيما قال مسؤولون إسرائيليون بوضوح: “لا مكان آمن في غزة”.
هذه ليست “أضرارًا جانبية”. بل خطة مُحكمة لنفي الحياة من غزة.
في يناير 2024، رفعت جنوب إفريقيا دعوى تاريخية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، تتهمها بارتكاب إبادة جماعية.
أمرت المحكمة بتدابير مؤقتة تُلزم إسرائيل بوقف أي أعمال إبادة، وتسهيل دخول المساعدات. لكن على الأرض، استمر القصف، وتجدد الحصار، وواصلت إسرائيل استخدام سلاح الجوع.
المقررة الأممية الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، تجرأت على قول الحقيقة.
وصفت ما يحدث بأنه “إبادة جماعية محتملة ترتكبها دولة استعمارية”، فتعرضت لهجمة دبلوماسية شرسة، اتُّهمت بالتحيّز، وطالبت إسرائيل بوقف تمويل الأمم المتحدة بسببها. ألبانيز قالت "ما نشهده في غزة ليس فقط جريمة حرب، بل نمط مستمر من الاستعمار، الفصل العنصري، والإبادة السياسية”.
لكن بدلًا من الرد على مضمون كلامها، اختارت إسرائيل والولايات المتحدة تشويهها، خوفًا من الاعتراف بالحقيقة.
الفضيحة لا تتوقف عند أفعال الجيش الاسرائيلي، بل تشمل الإعلام الإسرائيلي والغربي، وبعض الأوساط الأكاديمية.
أصدر باحثون في دولة الاحتلال، ما أسموه “دراسة علمية” تنفي وقوع أي جرائم ضد الإنسانية في غزة. لكنها ليست دراسة، بل مرافعة قانونية إيديولوجية لخنق الحقيقة قبل أن تصل إلى الرأي العام العالمي.
نحن نعيش زمنًا يُطلب فيه من الضحايا أن يتحلوا بـ”ضبط النفس” أثناء موتهم، وأن يُدانوا إن صرخوا طلبًا للحياة. لكن الحقيقة لا تحتاج إذنًا لتُقال. ما يحدث في غزة ليس حربًا، بل سياسة محو منهجية لهوية ووجود شعب. الإبادة ليست فقط بعدد القتلى، بل بسلب الحق في الوجود، بالحصار، بالتهجير، بتدمير المساجد والمخيمات، بقصف أطفال ينامون في خيام.
المجتمع الإسرائيلي، كما تعكسه أفعاله، ينزلق نحو انتحار أخلاقي جماعي باسم “الأمن” و”التفوق”.
قد تنجح إسرائيل في طمس الجرائم مؤقتًا، لكن الذاكرة لا تُقصف، والضمير الإنساني لا يُقهر.
وسوف يأتي اليوم الذي يُحاكم فيه القتلة، في المحاكم، وفي ذاكرة الشعوب، وفي روايات الناجين، وفي أسئلة أطفال غزة الذين قرروا أن لا ينسوا.